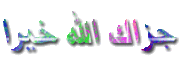حجج المرجئة والرد عليها :
ذكر ابن تيمية عنهم سبع حجج
الحجة الأولى :
قالوا الأعمال ليست من الإيمان لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال في كتابه فقال في غير موضع ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) البقرة277
ورد ابن تيمية قائلا وفصل الخطاب في هذا الباب أن اسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل الصالح أو الإسلام فإذا ذكر مجردا تناول الأعمال كما في الصحيحين ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) وأيضا أنه قال لوفد عبد القيس ( آمركم بالإيمان بالله وحده , أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ) وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام كما في حديث جبريل أنه سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان ففرق بينهما فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ) وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الإسلام علانية والإيمان في القلب ) فلما ذكرهما جميعا ذكر أن الإيمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال حسب القاعدة إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا في المعنى لا ينفكان حكما وإن تغايرا بحسب المفهوم وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا مجردا ومقيدا مقرونا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلام
وقد حرر أنواع العطف فقال عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما والمغايرة على 4 مراتب :
أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه ولا يعرف لزوم له مثل (خلق السماوات والأرض )
ويليه : أن يكون بينهما لزوم كقول ( ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق )البقرة 42 ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ) النساء 136 ,
والثالث :عطف الشيء على الشيء لاختلاف صفتهما وأن كان المسمى واحد مثل قوله ( سبح اسم ربك الأعلى , الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ) الأعلى 1-4 , وقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) البقرة 3-4 ,
والرابع :عطف بعض الشيء عليه أو عطف الخاص على العام كقوله ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) البقرة238 وقوله ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها ) الأحزاب 27 وقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) من هذا النوع - وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك فلا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لابد له من الأعمال الظاهرة وذكر الناس قولان :أن عطف الخاص على العام تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في العام وقالوا هذا في كل عطف خاص على عام وعليه يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل والقرآن ليس فيه ذكر الإيمان مطلق غير مفسر بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر فالمقيد كقوله ( يؤمنون بالغيب ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) والمطلق المفسر كقوله ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون ) الحجرات 15 , وقوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء 65 ,وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق فقد بين القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل مع التصديق وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين معناه الكتاب والسنة والإجماع ) راجع الإيمان والفتاوى جـ 7 و10 و18 .
الحجة الثانية :
أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فلم تكن من الإيمان كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) المائدة6 , وقال ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) الجمعة6 ,
فأجاب ابن تيمية ( أنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ومثل على ذلك بالحج فلم يذكر في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان كحديث وفد عبد القيس وحديث ضمام ابن ثعلبة حيث قال ( أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس ..أن نصوم هذا الشهر من السنة .. أن نأخذ الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا قال اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر) وذلك أن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد ) فتاوى جـ7
الحجة الثالثة :
قالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان
فأجاب ابن تيمية : وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح لأنه أتى بالواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فإن الله تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك وإن كان مثل الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقا للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك ) جـ7, 18
الحجة الرابعة :
أن الأعمال تدخل في الإيمان مجازا لا حقيقة فقال ابن تيمية ( والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه وإذا قالوا إن الأعمال من الإيمان من باب المجاز أمكنهم نفيها عنه لأن علامة المجاز صحة نفيه فقوله ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق ) مجاز , وقوله ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) حقيقة وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان) ج3
قال ابن تيمية ( ونحن نجيب بجوابين :
أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز وهو إبطال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في اللغة بل في النصوص الشرعية وأن الحق أن الكلام يختلف معناه بحسب دلالة الإطلاق والتقييد وهذا يمنع إبطال معاني النصوص كما صنع المبتدعة
وأما الجواب الثاني فيما يختص بهذا الموضع وهو لو صح وجود المجاز فما الحقيقة والمجاز في لفظ الإيمان هل الحقيقة هي دخول العمل فيه والمجاز خروجها منه أو العكس ؟
وتحرير ذلك في ثلاثة وجوه :
أولا إن صح وجود الحقيقة والمجاز فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة والمجاز إنما يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال وإنما يُدّعَى خروجها منه عند التقييد وهذا يدل على أن الحقيقة قوله ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) وفي حديث جبريل أراد الإيمان مع الإسلام قطعا كما أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام ولم يرد كل واحد مجردا ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازا وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث
وثانيا أن دخول الأعمال في الإيمان مجاز كالقول المرجوح عند الفقهاء بأن الأسماء الشرعية كالصلاة والحج على معناها اللغوي وما زاده الشارع هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل الاسم كما قال ذلك القاضي الباقلاني وأبو يعلى وقول الجمهور على خلاف ذلك ثم لو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ من الصلاة والحج ونحوها منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان ؟ وهذا لا يوجد
وثالثا يقال لمن جعل دخول الأعمال في الإيمان مجاز أن نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له واستمر في شرحه ونقض قولهم
الحجة الخامسة :
أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة إذا زال بعضها لم تبق عشرة والسكنجبين ( شراب مركب من حامض مع حلو ) إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه سكنجبينا قالوا لأنا إذا أدخلنا في الإيمان الأعمال صارت جزءا منه فيلزم تكفير وإخراج ذي الكبيرة من الإيمان كالخوارج والمعتزلة ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من إيمان كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفر وإيمان وادعوا أن ذلك خلاف الإجماع .
أما قولهم إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع فمما أجمع عليه أهل السنة من السلف أن الإيمان قول وعمل ظاهر وباطن فقد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته وليس ذلك كالإرادة مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد , وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ,فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة , فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط , بل لابد من العلم والحب , والعلم شرط في محبة المحبوب كما أن الحياة شرط في العلم , ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم , فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يُحب ويُعبد وأن يُحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به ,كمثل الشجرة في القرآن هي كلمة التوحيد فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها , فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من القلب لا محالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا , لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له , فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد , ومنها قصد القلب وعزمه هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟ فالقول الصحيح أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد جازم وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور , فالمؤثر التام يستلزم أثره فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما والفعل إذا صادف محلا قابلا تم وإلا لم يتم , فجنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع , وأن مذهب السلف وأهل السنة أنه متى وجد الإيمان الباطن وجدت الطاعات كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على وجهه وفلتات لسانه , والحاصل أن السعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل , ومن المعلوم أن الظاهر يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل على صلاح الباطن ولذا فإن الإيمان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن المنجي يوم القامة لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه .
وأما دعواهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فإن نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله ( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ) واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته فقال ( لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ) فإذا خرج من الإيمان بكبيرة يخرج إلى درجة أقل هي الإسلام ومعه أصل الإيمان .
وأما قولهم أن الحقيقة المركبة متى ذهب بعض أجزائها انتفت كالعشرة والسكنجبين فيقال لهم إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء وهذه المنفية في مثل قوله ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... ) ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه , فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية له وزال الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكنجبين وهذا بحث لفظي فنحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة ما بقيت كما كانت ويبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ؟ فيقال لهم : المركبات على وجهين منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم كاسم العشرة والسكنجبين ومنها ما لا يكون كذلك فيبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء مثل جميع المركبات المتشابهة الأجزاء وكثير من المختلفة الأجزاء فالمكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والإيمان فغالب المركبات من هذا النوع ومن ثم لا يصح قولهم إذا زال جزؤه لزم زوال اسمه ومعلوم أن لفظ الإيمان من هذا الباب فإذا زالت إماطة الأذى ونحوها لم يزل اسم الإيمان وقوله ( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ) فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك , وأن أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر وبعضها قد لا يكون شرطا فيه وبعضها ينقص المركب بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل فمثال ما كان شرطا من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كان كافرا بالكل ومثال ما كان من الكمال المستحب عدم إماطة الأذى وعدم رفع الصوت بالإهلال والاضطباع والرمل في الشوط الأول من الحج فينقص بزوالها عن كماله المستحب , وهكذا في أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا فلا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال البقية ما دام أنها مختلفة فيما بينها ) الإيمان الأوسط وج7
أما دعواهم الإجماع على قولهم لا يجتمع فيه إيمان وكفر ولا يكون فيه بعض إيمان وكفر فيقول في درء التعارض8/95 والإيمان 387 ( وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدق ولا فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين التي لا يكون الرجل مؤمنا أو لا يتم دين الإسلام إلا بها ونحو ذلك , وهذا ما وقع للمرجئة في هذه المسألة حيث اعتقدوا أنه لا يجتمع في العبد ما هو إيمان وما هو كفر ( يعني كفر أصغر ) وظنوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين فوقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة . أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه فيجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما ثبت في الصحيح ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ) وقال ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ) وقال ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) وقال ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم ) وقال ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) وقال ( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) ومن القرآن الذي نسخت تلاوته الحديث ( لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) وقال ( ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه ) وقال ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) وقال ( ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكواكب وبالكواكب ) ومن الآثار قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ( إن الإيمان يبدو لـُمظة بيضاء في القلب فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله وإن النفاق يبدو لُمظة سوداء في القلب فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب كله وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه ( الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ) وقال حذيفة رضي الله عنه ( القلوب أربعة قلب أغلف ( عليه غشاء عن سماع الحق ) فذلك قلب الكافر وقلب مصْفح ( ذو وجهين )وذلك قلب المنافق وقلب أجرد ( ليس فيه غل ولا غش ) فيه سراج يزهر ( يتلألأ بياضا ) فذلك قلب المؤمن وقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق فيه مثل قرحة يمدها قيح ودم فأيهما غلب عليه غلب) وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق أي النفاق الذي لا ينقل عن الملة وكذا الكفر الذي لا ينقل عن الملة ) الإيمان 296 وج7 .
الحجة السادسة : أن الإيمان في اللغة هو التصديق
قال ابن تيمية ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا قال القاضي أبو بكر الباقلاني في التمهيد ( فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان عندكم ؟ قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب فإن قال فما الدليل على ما قلتم ؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق لا يعرفون إيمانا في اللغة غير هذا ويدل علي ذلك قوله تعالى ( وما أنت بمؤمن لنا ) يوسف 17 أي بمصدق لنا ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي لا يصدق بذلك فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان في اللغة لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان دليل على أن الإيمان في اللغة هو الإيمان اللغوي ومما يبين ذلك قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وقوله ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات ) هذا لفظه وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان .
فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين والدين كله تابع لهذا وكل مسلم يحتاج إلى ذلك أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ؟! ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي أعظم من تواتر لفظ الكلمة فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات وهذا كلام عام مطلق .
أما الكلام المفصل ففي مقامين :
المقام الأول دعوى الترادف فمما ينبغي أن يعرف أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة والحج والإيمان ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والبسط ولفظ المعروف في قوله ( وعاشروهن بالمعروف ) ونحو هذا وقال ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ما يراد بها في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن هناك يعرف معناها فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي لم يقبل منه واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب بل يجب الرجوع في هذه المسميات إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ وماذا عني بها الله ورسوله ولا يجوز أن يحمل كلام الرسول على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه .وذلك من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟ وهب أن المعني يصح إذا استعمل في هذا الموضع فلم قلت بوجوب الترادف ؟ ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ وإذا قال الله ( أقيموا الصلاة ) ولو قال القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة والتزموا الصلاة وافعلوا الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا يدل هذا على معنى( أقيموا ) فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك
والوجه الثاني ليس في الآية ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر بل معنى الآية لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين ولم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه على الناس وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر , فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم بوجود شيء مما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذبه بلسانه أنهم يقولون هو مؤمن به بل ولو عرف بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به ولا يوجد في كلام العرب شاهد واحد على ما ادعوه ثم يقال له من نقل هذا الإجماع على ما تقول ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع ؟ وما معنى أهل اللغة ؟ أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والخليل وغيرهم أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك , الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا , الرابع أن هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن ومعانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم , الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق
والوجه الثالث : توجد فروق أربعة بين الإيمان والتصديق لغة
الفرق الأول التعدي فإن الفعل صدق يتعدى بنفسه ولا يتعدى بغيره إلا إذا ضعف عمله بتأخير وتقديم مفعوله عليه أو كونه اسم فاعل أو مصدرا ونحو ذلك تقول صدقته وأنا به مصدق وأنا مصدق له وأما الفعل آمن فإنه يتعدى بغيره ولا يتعدى بنفسه إلا إذا كان بمعنى الأمان ضد الإخافة تقول آمنت به وآمنت له إذا أردت معنى الأمان قلت أمّنته وهذا خلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت التصديق أمنته كما يقال أقررت له ومنه قول آمنت له كما يقال أقررت له ,
الفرق الثاني الإيمان يستعمل في الخبر عن الأمور الغائبة وفي خبر يؤتمن عليه المخبر من الأمور التي فيها ريب وفي الحقائق الثابتة فإذا أقر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار المشهودة والغائبة ويختص بمتعلقات الذوات المرتبطة بمعاني الحب والبغض فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر دون الحقائق الثابتة وهما خبر عن خبر بخلاف الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرارا أو إنكارا أو حبا أو بغضا أو طمأنينة أو نفورا كما في الدعاء عند استلام الحجر ( اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ) وقال ( تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا بكلماتي أو برسلي ) وقال تعالى ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه ) ففي جميع هذه الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل ,
الفرق الثالث :من جهة المقابلة والتضاد فالتصديق يقابله التكذيب وأما الإيمان فيقابله الكفر والكفر لا يختص بالتكذيب فقط فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط عُلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلابد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق ,
الفرق الرابع :من جهة المعنى فالإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقرار والطمأنينة وهذا أقرب من تفسيره بالتصديق مع أن بينهما فرقا فلفظ الإقرار يتضمن الالتزام على وجهين أولا الإخبار والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد وثانيا إنشاء الالتزام كقوله ( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد ثم مجرد التصديق في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا .
أما المقام الثاني : فعلى فرض التسليم بالترادف بين الإيمان والتصديق
توجد ستة أجوبة
الجواب الأول : فقولهم التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ممنوع بل الأفعال تسمى تصديقا كما في الصحيح قوله ( العينان تزني وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) وكذا قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف قال الجوهري الذي يضرب به المثل في ضبط اللغة والصديق مثال الفسيق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل . وقال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ,
والجواب الثاني أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص فالإيمان تصديق مخصوص يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل عند أهل الحديث وحينئذ يكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص ,
والجواب الثالث أنه وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم وهذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى
والجواب الرابع أن يقال أن اللفظ باق على معناه في اللغة ومتروك على ما كان ولكن الشريعة زادت فيه أحكاما وضمت إليه شروطا وقيودا ,
والجواب الخامس أن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي ,
والجواب السادس :أن يقال إنه منقول عن معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة ونحوها .
فكل هذه الأجوبة يكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم لهم دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها فلما خاطبهم باسم الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا والدعاء الذي صفته كذا وكذا فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق كقول ( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ) ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه من غير تغيير لغة ولا نقل لها فالتحقيق أن الشارع لم ينقل تلك الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها فتصرف الشارع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية إما بتخصيصها ببعض معانيها وإما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب ومناسبة ) . ج7 وشرح العمدة
الحجة السابعة :
الاستدلال بأحاديث الوعد مثل الحديث ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) وحديث الجارية أن رجلا جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن على عتق رقبة مؤمنة فإن كانت هذه مؤمنة أعتقها ؟ قال لها رسول الله ( أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال فاعتقها فإنها مؤمنة ) وفي حديث البطاقة( إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول عز وجل إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) وحديث الاندراس وقوله تعالى ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات ) قالوا ومعلوم أن امتحانهن إنما هو مطالبة لهن بالإقرار بالشهادتين كما في حديث الجارية وقالو أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه الإقرار بالشهادتين وأولوا لأجل تلك النصوص ما يقابلها من نصوص الوعيد التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الذنوب كقوله ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم ) ( من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ) وقالوا المقصود ليس مثلنا وليس من خيارنا وقالو إن لم يكن مؤمنا فما هو ؟ ولا يدخل الجنة نمام- ديوث – أو من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) قالو لا يدخلها أول الداخلين
فأجاب شيخ الإسلام من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول أما الذي عليه أهل السنة وعامة علماء السلف فهو الإيمان بالوعد والإقرار بالنصوص الواردة في هذا الباب على ما دلت عليه من المعاني وإمرارها كما جاءت وأنه حق على ظاهرها اللائق بها ويجمعون بينها ويفسرون بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها أو تأويلها بتأويلات تخرجها عن مقصود الشرع كما يصنعه من يحرفها ويسمي تحريفها تأويلا فنصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة وجاءت نصوص فسرتها وقيدتها وبينت أن لحوقها بالمعين لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع في حقه فالوعيد سبب مقتضِ للعذاب والسبب يتوقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه
الوجه الثاني أن من قال لا إله إلا الله على وجه خلص به من الشرك الأكبر ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيدخل الجنة ولكن تنقص درجته بقدر ذنوبه وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار والمنافقين كلهم كانوا يقولن لا إله إلا الله فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة لآن القرآن قد دل على أن (لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) لمن تاب وهذا متفق عليه بين المسلمين ولا نشهد لمعين أنه في النار لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه فلحوق الوعيد مشروط بشروط وانتفاء موانع في حقه وحديث الجارية له جوابان آخران غير ما سبق كلاهما منقول عن الإمام أحمد الأول أن روايات الحديث لم تتفق على وصف الجارية بأنها مؤمنة وإنما اتفقت على الأمر بالإعتاق فحسب والثاني قد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة هذا معناه واختاره شيخ الإسلام أن حكمها في الدنيا حكم المؤمنة لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب وكذلك آية الممتحنة ( فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ) ولو كان ذلك إيمانا حقيقيا لما قال ذلك وكذلك إجماع المسلمين أن الكافر إذا أسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين وذلك لإجراء أحكام الإسلام عليه لأن الشارع جعل ذلك أمارة لإجراء الأحكام
والوجه الثالث : التفسير الصحيح لنفي الإيمان في نصوص الوعيد أن الذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم أن نفي الإيمان في هذه النصوص لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه فمن قال المنفي هو الكمال إن أراد نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع في كلام الله تعالى ورسوله فتوجد حالتان
1ـ فإذا نفي الإيمان من كل وجه وعن كل اعتبار ، ولم يثبته بأي وجه أو بأي اعتبار ، ولم يثبت مع هذا النفي إسلاما بإشارة لفظية أو معنوية ، وتكرر النفي في مناسبات شتى ووصف مرتكب نفس الفعل بأوصاف أخرى مثل : الشرك أو النفاق أو الكفر أو نفي الصلة دل على أن المقصود من النفي هو عدم ثبوت الأصل فينقل عن الملة
2 ـ وإذا نفي الإيمان وأثبت الإسلام بإشارة لفظية أو معنوية يكون إثباتا للأصل ونفيا للتمام ( نفي الإيمان الواجب " المرتبة الثانية من مراتب الدين " وإثبات الإيمان المجمل " المرتبة الأولى من مراتب الدين " ) .
بعض التوضيحات
لما فرق الإمام أحمد بين المعرفة والتصديق كان يعني بأن التصديق يدخل فيه عمل القلب لكن المعرفة لا يدخل فيها عمل القلب فإذا دخل في التصديق عمل القلب يلزم عنه عمل الجوارح مع القدرة والإرادة
فقال ابن تيمية أن لفظ التصديق ولفظ الإقرار ولفظ الشهادة يتضمن الالتزام والانقياد أما لفظ الخبر والمعرفة فلا يدخل فيه العمل إلا إذا أثبت معه العمل – ولفظ المعرفة لا يدخل فيه الانقياد القلبي إلا إذا أثبت معه الانقياد القلبي – الخبر والمعرفة يتطلب معه الانقياد الباطن
وكذا الإقرار يتضمن خبر والتزام – قول وتصديق مع عمل القلب
قال تعالى ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) أثبت تكذيب اللسان ونفى عنهم تكذيب القلب
وقال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) أثبت لهم يقين القلب مع تكذيب اللسان
فلا يمكن لإنسان أن يعرف علما ثم يستيقن ضده وهذا ينفي الخبر النفساني الكاذب الذي أثبتوه فزعموا أنه في نفسه خبر نفسي كاذب اتباعا للنفس فيتمنى شيئا فيصدقه وهو غير قائم فيخدع نفسه أو يكره شيئا رغم معرفته أنه حق وصحيح ويكذبه بقلبه عنادا للحق فيكذب ما أيقن من صحته . فهو نفس وجود الخبر النفسي الكاذب
فقرر ابن تيمية أن التكذيب يكون بالقلب أو اللسان
إما مكذب قلبا ولسانا كالكافر أو مكذب بالقلب كالمنافق أو مصدق بقلبه مكذب بلسانه كالجاحد أو مصدق بقلبه ومصدق بلسانه وهو المؤمن فإذا كذب القلب فهو المكذب ويعني أن القلب لم يصدق ولم يتيقن من صحة الحق أصلا فلم تكن في قلبه معرفة يناقضها تكذيب فالمعرفة والتكذيب ليسا أمرين متناقضين أصلا فينتفي وجود الخبر النفساني الكاذب ، وهذه البدعة لا زالت تدرس في الأزهر حتى الآن عن طريق بدعة الأشاعرة الجهمية وهو العلم الرسمي المعتمد في الأزهر وبالتالي لا يوجد عندهم توحيد العبادة أو الألوهية ينكرونه تماما فالتوحيد عندهم نوع واحد فقط هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات
أما الإسلام فيفسر عندهم بأربعة معاني :
1- الإسلام كأصل الدين هو إخبات قلبي ينقل المعرفة إلى تصديق قلبي خال من الانقياد
2- هو الشهادتين أو الكلمة التي يثبت بها الإسلام
3- هو المباني الخمسة ( بني الإسلام على خمس ... ) الحديث
4- هو الطاعة في فروع الأعمال
نتفق معهم في أنه الطاعة في فروع الأعمال وأنه المباني الخمسة وأنه الكلمة أو الشهادتين
ونختلف معهم في أصل الدين أنه إخبات قلبي ينقل المعرفة إلى تصديق قلبي خالٍ من الانقياد
نحن أهل السنة ننفي هذا المعنى ونثبت بدلا منه أنه توحيد العبادة أو الألوهية وهذا فارق مهم جدا وننفي وننكر وجود الخبر النفساني الكاذب
لفظ العبادة عندهم
1- العبادة كأصل الدين هي الطاعة في الاعتقاد
2- العبادة هي النسك خاصة ( معنى خاص )
3- العبادة هي الطاعة في فروع الأعمال
نتفق معهم في معنيين هي النسك خاصة أو هي الطاعة في فروع الأعمال
ونختلف معهم في تعريف العبادة بالطاعة في الاعتقاد لأن هذه الطاعة في الاعتقاد لا وجود لها وليس لها معنى
فالاعتقاد من جنس الخبر والمعرفة يلزمه تصديق أو تكذيب
أما الطاعة من جنس العمل تكون في الأمر والنهي
فلا يصح القول : صدقوا الرسل فيما أمروا وأطاعوهم فيما أخبروا
بل الصحيح أن تقول صدقوا الرسل فيما أخبروا وأطاعوهم فيما أمروا
لا يوجد شيء اسمه طاعة في الخبر أو طاعة في الاعتقاد
الخبر والاعتقاد يقابله تصديق أو تكذيب
والأمر يقابله قبول أو رد والقبول ينبني عليه الدخول في الأعمال
فيقبل الأمر أولا ثم يدخل في العمل
فقرر ابن تيمية أن : الكلام خبر وإنشاء والإنشاء أمر ونهي ( طلب )يقابل بالطاعة أما الخبر فيقابل بالتصديق أو التكذيب فنقول صدقوا الرسل فيما أخبروا وأطاعوهم فيما أمروا
وقرر أن العبادة بالنسبة لأصل الدين هي الطاعة بمعنى قبول الأمر
وبالنسبة لباقي الدين هي الطاعة في فروع الأعمال
والعبادة أمر تعبدي وتنقسم إلى عبادات وعادات ومعاملات
فالعبادات : غير معقولة المعنى ( لا تعلل ولا تبرر ) – تفتقر إلى نية ( لا تصح شرعا بدون النية ) – توقيفية الأصل فيها الوقف حتى تشرع وليس فيها اجتهاد والتفريع فيها قليل ( خذوا عني مناسككم – صلوا كما رأيتموني أصلي ) – حق خالص لله وحده ( أداؤه طاعة والتقصير فيه معصية وصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك أكبر )
أما العادات والمعاملات : معقولة المعنى تعلل وتبرر – لا تفتقر إلى نية فتصح بدون نية وتتحول لعبادات بنية التقرب والتعبد – ليست توقيفية فالأصل فيها الإباحة والتفريع فيها كثير وتحتاج تتبع المعاني والنظر في المقاصد وتبنى عليها اجتهادات حسب المعنى – فيها كل أنواع الحقوق من حقوق العباد والحقوق المشتركة بين الله والعبد
هذا هو مختصر رد المحور الأول للإرجاء وهو الإرجاء القديم بتفريعاته
من كتابي ( رد طوائف الإرجاء ) أبو أحمد صفوت ين عبد الله
يتـــــــــــــــــــبع