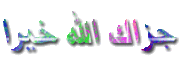الخطاب السياسي الإسلامي ومفهوم "الحركة"
هذا المقال | 24.08.12 |
بقلم شريف محمد جابر
الخطاب الشرعي الإسلامي هو:
المعيار الذي نحدِّد من خلاله شرعية الأعمال والأشياء مِن عدمها، وهو أداء واجب البلاغ المُبين لحقائق هذا الدِّين.
أما الخطاب السياسي الإسلامي:
فهو يَهدف إلى حماية مصالح المسلمين بحسب حالة ضعفهم وقوتهم، وهو - وإن كان لا يجوز له أن يُصادِم الخِطاب الشرعي - ليس مُقتصِرًا على نصوص الشرع، وإنما هو خطاب بشري يُراعي إمكانيات الواقع بشكل أساسي، ويتحرَّك في نطاق المُمكِن رعايةً لمصالح الأمة؛ ليَصل مرحلةً بعد مرحلة إلى أهدافه النهائية، والتي يَرسمها الخطاب الشرعي؛ أي: هو يَخدم الخطاب الشرعي ولا يُصادمه، فالخطاب السياسي من هذا المُنطلَق يحمل صفة "الشرعية"، فهو خطاب سياسي شرعي.
وإذا عُدْنا إلى السيرة النبوية، وسِيَر الصحابة - رضوان الله عليهم - نجد نماذج رائعة يَبرز من خلالها هذان الخطابان: الخطاب الشرعي، والخطاب السياسي.
نموذج جمع القرآن:
لقد جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن الكريم في مصحفٍ واحدٍ، وبالعودة إلى نصوص الكتاب والسنة لا نجد نصًّا واحدًا يَأمُر بهذا الفعل، رغم أنه متعلِّق بأحد أهمِّ عناصر هذا الدِّين وهو القرآن الكريم، ولكنَّ إجماع الصحابة على جمع القرآن هو أكبر دليل على شرعيَّة الأعمال التي تَخدم الإسلام والمسلمين حتى لو لم يَرِدْ فيها نصٌّ من الكتاب أو السنة، كان إجماعهم نابعًا من مراعاة مصلحة حفْظ الدِّين ومصلحة المسلمين أجمعين؛ لِما رَأَوْا من تغيُّرات في الواقع جعلتهم يتَّخذون هذا الإجراء الخادم للدِّين، وغير المُصادِم له، رغم كونه ليس من النصوص الشرعية، ولم يأتِ نصٌّ شرعي يتحدَّث تفصيلاً عن واجب جمع القرآن، وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].
حقائق الحبَشة:
لقد جاء هذا الدِّين ليُسقط شرعية كلِّ نظام قائم على غير قاعدة العبودية لله وحده، ولم يكن يخصُّ في ذلك أوضاع المشركين في الجزيرة عن غيرهم في سائر أنحاء العالم؛ فقد كان العالم آنذاك يعجُّ بالجاهلية في كل أصقاع الأرض؛ جاهلية الأفراد والجماعات في العقائد والقِيَم والأخلاق والأوضاع والنُّظُم، وكان مجرَّد الصدْع بأصل هذا الدِّين - وهو عبادة الله وحده لا شريك له - يعني في الواقع إسقاطَ شرعيَّة كلِّ هذه الجاهليات.
كانت الجماعة الأولى التي نزل عليها هذا الدِّين مُكلَّفةً أن تُقيمه كوضع جماعي، كما كانت مكلَّفةً به على نطاق الالتزام الفرديِّ، ولاقتْ في سبيل ذلك البطش الشديد من الجاهلية التي تُحيط بها، ومن خلال ذلك يُلاحظ الدارس للسيرة النبوية وجود خطٍّ يمكن أن نسمِّيه "خطًّا حركيًّا"، ميزته أنه يَنتقِل بحال الدعوة مرحلةً بعد مرحلة وصولاً إلى أهداف هذا الدِّين، ومنها الاستخلاف والتمكين والتأمين ونشر الدعوة على نطاق أوسع.
كانت "حقائق الحبشة" مفصلاً هامًّا في تاريخ هذه الدعوة، فيه مِن العبر والدروس لنا ما يجب أن نَلتفِت إليه جيدًا حين نُريد التحرُّك في واقعنا المعاصر بُغيةَ إعزاز هذا الدِّين والتمكين له.
اشتدَّ البطش على الصحابة الكرام في مكة من قريش، فكان التوجيه النبوي: ((إن بأرض الحبشة ملكًا لا يُظلَم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه))؛ (صحّحه الألباني).
وكان الخطاب السياسي الشرعي الموجَّه إلى مَلِك هذا النظام الجاهلي على لسان الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نَعرِف نسبه وصِدقَه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمَرنا بصدْق الحديث، وأداء الأمانة، وصِلة الرحم، وحُسن الجوار، والكفِّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وشهادة الزور، وأكْل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمَرنا أن نعبد الله لا نُشرك به شيئًا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة - قالت: فعدَّد عليه أمور الإسلام - فصدَّقناه وآمنَّا به، واتَّبعناه على ما جاء به، فعبدْنا الله وحده لا نشرك به شيئًا، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحلَلْنا ما أحلَّ لنا، فغدا علينا قومنا فعذَّبونا وفتَنونا عن ديننا ليردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله - عز وجل - وأن نَستحلَّ ما كنَّا نستحلُّ من الخبائث، فلما قهَرونا وظلَمونا، وشقُّوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجْنا إلى بلدك، واخترناك على مَن سواك، ورغبْنا في جوارك، ورجونا ألا نُظلَم عندك أيها الملك"؛ (الهيثمي في مجمع الزوائد، ومسند أحمد، والصحيح المسند للوادعي، وهو صحيح).
ويَلفتُ النظر في هذا الخطاب أمور ثلاثة:
• أنَّه يبيِّن الحقائق الشرعية ويجهَر بها دون لبس أو غموض أو تحريف أو إخفاء؛ أداءً لواجب البلاغ.
• أنَّ هذا الخطاب السياسي يَخدم أهداف الدِّين، ومقصوده تحصيل مصالح الإسلام والمسلمين.
• أنّه لا يَتصادم مع الأحكام والحقائق الشرعية.
ثم لم يَقتصِر الأمر على مُخاطَبة رأس هذا النظام "الجاهلي" "العادل" واللجوء إليه ومُخاطبته بالحسنى وتفضيله على النظام "الجاهلي" القرشي "الظالم"، بل لجأت الجماعة المسلمة آنَذاك إلى دعم هذا النظام، الذي يَرحمها ويَحميها ويُتيح لها حريَّة الدعوة والتحرُّك، وإعانته في وجه مَن خرَج ليناوئه، تقول الراوية - أمُّ سلمة - رضي الله عنها - في نفس الرواية: "وأقمْنا عنده في خير دار مع خير جار، فوالله إنه لعلى ذلك إذْ نزل به مَن يُنازعه في ملكه، قالت: والله ما علمنا حزنًا قطُّ كان أشد مِن حزنٍ حزنَّاه عند ذلك؛ تخوُّفًا أن يَظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف مِن حقِّنا ما كان النجاشي يعرف، قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن رجل يَخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا، قالت فقال الزبير بن العوام: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سنًّا، قالت: فنفَخوا له قِربةً فجعلوها في صدره فسبَح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها مُلتقى القوم، ثم انطلَق حتى حضرهم، قالت: ودعونا الله - عز وجل - للنجاشي بالظهور على عدوِّه والتمكين له في بلاده واستوسَق عليه أمر الحبشة فكنَّا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة".
لقد اعتبروه "خير دار مع خير جار" رغم كونه نظامًا جاهليًّا! ولكن توصيفه الشرعي والتعامل معه وفْق الأحكام الشرعية شيء، والاستفادة مما يُتيحه ووصفه بالأوصاف الحسنة التي يستحقُّها، بل والتعاون معه ودعمه لحماية المسلمين شيء آخَر، لا يَتعارضان إطلاقًا.
وقد دعا الصحابة له كما تقول أمُّ سلمة - رضي الله عنها -: "ودعونا الله - عز وجل - للنجاشي بالظهور على عدوِّه والتمكين له في بلاده"، فلم يكن دعمهم هذا له، ودعوتهم تلك "إضفاءً للشرعية" على نظام جاهلي، ولا إقرارًا به كوضع نهائي يَركن إليه المسلمون، والدليل هو أنَّ الجماعة المُسلمة لم تلجأ إليه آنذاك كحلٍّ نهائي بجميع أفرادها، بل ظلَّت تشقُّ طريقها الصعب بخطوات واثقة مرحلةً بعد مرحلة حتى وصلتْ إلى التمكين الإسلامي وفق الأسس الإسلامية، وفي هذا درس كبير للحركة الإسلامية المعاصرة، فلا يجوز للمسلمين أن يُعطوا الشرعية للنظم والهيئات التي تحميهم وتعدل معهم، وتقف في مواجَهة مَن يريد البطش بهم، بل هؤلاء يَشكُرون كما شكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعد معركة بدر صنيعَ المُطعم بن عدي الذي أجاره؛ فقد جاء في صحيح البخاري: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًّا، ثم كلَّمني في هؤلاء النتنى، لتركتهم له"، وكذلك يتم التعاون مع الأوضاع التي تتَّفق بعض أهدافها مع أهداف الحركة الإسلامية، كما كان من شأن قبيلة خزاعة، فقد جاء في السيرة النبوية: "وكانت خزاعة - مسلمهم ومشركهم - عَيبة نُصحٍ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتهامة، صفقتهم معه، لا يُخفون عنه شيئًا كان بها"؛ (السيرة النبوية لابن هشام)، ولكن على ألا تقدِّم الحركة الإسلامية تنازلات تمسُّ بثوابتها الشرعية بسبب هذا التعاون، بل ينبغي أن يكون خادمًا لهذه الثوابت، وعاملاً على تحقيقها وترسيخها.
لقد أظهرت لنا حقائق الحبشة - وغيرها من حقائق الجماعة المسلمة الأولى - أنَّ الحركة آنذاك لم تقتصر على التمسُّك بالأحكام الشرعية والخطاب الشرعي دون وجود "خطاب سياسي" و"حركة سياسية" تهدف إلى شقِّ الطريق في الواقع بخطوات مرحليَّة لتمكين دين الله في الأرض؛ كي يؤدوا رسالته بمضمونها الشامل كما جاء من عند الله.
بكلمات أخرى: لم تَقتصر الجماعة الأولى على "البيان" في طريق دعوتها، بل كانت تسير في خطٍّ "حركيٍّ" يهدف بشكل أساسي إلى حماية الدعوة والجماعة المسلمة، وإيجاد المنَعة والقوة والنصرة التي تجعلها تقيم شرع الله في الأرض، وتنطلق لنشر دين الله، مع الاستعصاء على الكسْر قدر الإمكان، وقد اعتمدت في هذا الخطِّ "الحركي" كلَّ ما وفَّره الواقع آنذاك من إمكانيات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف، مع الالتزام بالثوابت الشرعية وعدم التنازل عنها، ومن أهمِّ هذه الثوابت واجب البلاغ المبين؛ بلاغ رسالة التوحيد وما تَقتضيه من تكاليف في حياة الناس.
فالسيرة النبوية - لمن يقرؤها بقلب حاضر - كلُّها "حركة"، وكلُّها سعيٌ حثيث واستخدامٌ لكلّ الوسائل المتاحة بُغية تحقيق أهداف الرسالة الأخيرة، والتي كتب الله لها أن تكون آخِر رسالة من "الوحي" تُبعث إلى البشرية كافَّةً.
وثمَّت بعدٌ آخر للقضية، ينفي صفات "الجمود" و"التقوقع" عن الحركة الإسلامية:
بيَّن الإسلام طريقة تنفيذ كل شعيرة من شعائره؛ ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي))؛ البخاري، ((خذوا عنِّي مناسِكَكم))؛ (صحَّحه الألباني في صحيح الجامع)، وأكَّد على ثبات الأحكام الشرعية المتعلِّقة بالواقع الثابت؛ كتحريمه للربا والزنا والخمر والميسر وغيرها، فهذه قضايا تتعلَّق "بالإنسان" كإنسان، بكيانه الثابت وواقعه الثابت (الشعائر ونزعات الإنسان وشهواته وثبات هذه المحرمات في الأرض حتى تقوم الساعة)، ولا تتغيَّر هذه الأحكام على تطاول الزمان.
فالصلاة هي الصلاة، مهما تغيَّر الواقع، والصيام والحج والزكاة وسائر شعائر الإسلام التعبُّدية.
وكذلك الأمر مع الأحكام الشرعية الأخرى؛ فهي إما واجب، أو حرام، أو مستحبٌّ، أو مكروه، أو مباح، فالواجب يظلُّ واجبًا، والحرام يظلُّ حرامًا، ويقوم بهما المسلم في كل عصر وفي كل وقت متى كان ممتلكًا للقدرة على القيام بهما؛ فالزنا والربا والخمر والميسر لم يتغيَّر، وما زالت وستبقى محرَّمةً حتى قيام الساعة.
ولذلك فإنَّ هذه الأحكام الشرعية بدءًا بشعائر التعبُّد مرورًا بالواجبات الشرعية الأخرى والمحرَّمات، كلها متعلٍّقة ومرتبطة بواقع "ثابت"، لا يتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، ولذا وجب تنفيذها والقيام بها بالطريقة التي أقامها بها رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وهذا مقتضى الالتزام بسنَّتِه - عليه الصلاة والسلام.
أما حركته - عليه الصلاة والسلام - التي استهدفت الدعوة لدين الله، والبحث عن الحماية والمنَعة والنصرة لهذه الدعوة، أما هذه "الحركة" فقد كانتْ عبارة عن خطِّ سير في واقع معيَّن، تفاعَل به مع الأحداث، وتحرَّك فيه وفْق ما يتيحه الممكن في ذلك الواقع، مرحلةً بعد مرحلة، وخطوةً على إثر أخرى، وصولاً إلى أهداف التمكين الشرعي التي تحقّقت بفضل الله في المدينة المنورة، عن طريق نصرة أوسها وخزرجها لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.
هذه المنهجية الحركية في التعامل مع الواقع، والتي قام بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام - تُعطينا درسًا مهمًّا علينا أن نتمسَّك به، وهذا من واجب الاقتداء به - عليه الصلاة والسلام - وهو: عدم الجمود وعدم التقوقع في الحركة، واقتناص ما يتيحه الواقع من فُرَص، والعمل على حماية الدعوة وطرق جميع الأبواب الشرعية المتاحة لإعزاز دين الله والتمكين له، فهذا هو منهجه - عليه الصلاة والسلام - وعلينا نحن أن نستمسك بهذا المنهج ونقتدي به.
لا يسعنا أن نُعيد تَكرار الأحداث التي قام بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - ذلك أنَّها كانت مرتبطةً أشدَّ الارتباط بالواقع الذي عاشه - عليه الصلاة والسلام - ومترتَّبةً على هذا الواقع المختلف في كثير من جوانبه عن واقعنا المعاصر، ولكنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - أعطى المسلمين من خلال القدوة النبوية وسيلةً تضمن استيعاب "الواقع المتجدِّد"؛ ليواجهه المسلمون بأدوات من جنسه، مع انضباطهم بالحكم الشرعي.
فحين كانت "الهجرة" وسيلةً متعيَّنةً لإتمام مشروع إقامة دين الله في الأرض، حسبما اقتضاه الواقع الذي كان فيه المسلمون حينها (مسلمون في مكة، وآخَرون في المدينة ينتظرونهم)، فإن هذه الوسيلة التي هي أداة لصيقة بالواقع النبوي آنذاك، لم تكن "حكمًا شرعيًّا" ينبغي التمسُّك به لإقامة الدين في كل عصر؛ إلا إذا قامت شروط وجودها وأسباب هذا الوجود في الواقع، فحينها تَفرض هذه الوسيلة نفسها كسياق طبيعي لحركة التمكين.
لقد كانت الحركة النبوية المتوجِّهة للتمكين تواجه واقعًا معيَّنًا، وتتعامل معه وفق إستراتيجية "تحقيق الممكن" الذي يخدم أهداف الإسلام، وينضبط بضوابطه الشرعية، فأرسل الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - أصحابه الكرام إلى الحبشة لا ليُقيموا دولة، ولكن ليوفِّروا بيئةً تحميهم من بطش قريش؛ "حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه"، ولو آمَن أهل مكة واستجابوا لدعوة الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - وتنازلوا عن كبرهم وصدِّهم، لما احتاج - عليه الصلاة والسلام - إلى إرسال جماعة من المسلمين إلى الحبشة كي يَحتموا من بطش قريش، ولما احتاج إلى طلب النصرة والمنعة من القبائل بعد أن صدَّه أهل مكَّة صدودًا كبيرًا، ولذلك كانت أحداث السيرة النبوية "عبرًا ودروسًا مستفادةً" نَستخلِص منها منهج الدعوة ومنهج العمل، ولكن لا نَعتبر كلَّ أفعاله فيها - عليه الصلاة والسلام - "أحكامًا شرعيَّةً" واجبة الالتزام في كل وعصر وفي كل واقع، ولا نُحاول "استنساخ التجربة" بمحاولة تكرار الأحداث؛ لأنَّ الحركة آنذاك كانت تواجه واقعًا مغايرًا في الكثير من جوانبه لواقعنا المعاصر، فنأخذ من تلك الحركة النبوية الشريفة ما يشكِّل لنا "معالم الطريق"، وننضبط بضوابط الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة، ولكن لا نسعى إلى تكرار الأحداث التي نشأت في سياق خاص بها، وفي واقع مغاير لواقعنا، بل الاقتداء بمنهجه - عليه الصلاة والسلام - في إقامة دين الله في الأرض يوجب علينا أن نَستنفِد إمكانيات الواقع الذي نعيشه، كما استنفد - عليه الصلاة والسلام - إمكانيات الواقع الذي عاشه، وأن نتحرَّك إلى أهدافنا مرحلةً بعد مرحلة بما توفِّره إمكانيات الواقع، وصولاً إلى الأهداف الكبرى للإسلام، وهذا ثابت باستقراء السيرة النبوية الصحيحة.